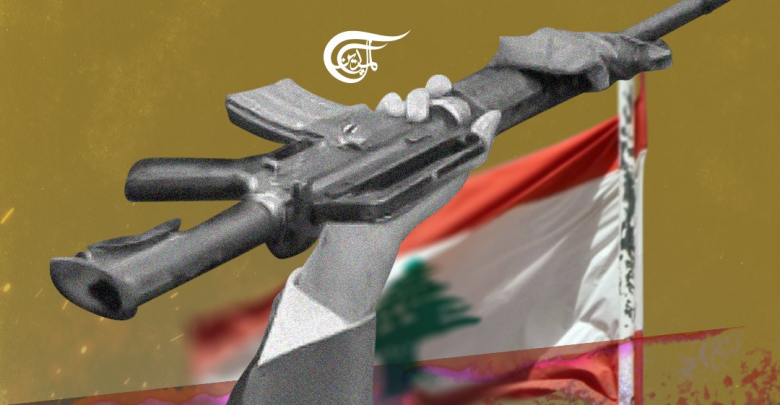
ويسألونك عن السيادة وقرار الحرب والسلم
قاسم عز الدين
من عجائب زمان الولَه بالعبودية أن يتمنطق سياسيون و”تغييريون” بإزالة سلاح المقاومة أساساً لبناء سيادة الدولة، لكنه أساس لزخرفة صورة مزرعة الموز في سوق التجارة السياسية.
ويسألونك عن السيادة وقرار الحرب والسلم
جبال من الدراسات في القانون الدولي والعلاقات الدولية منذ القرن السادس عشر حتى ابتداع تعاليم مؤسسات “المجتمع الدولي”، تخلص إلى أنّ احتكار العنف وقرار الحرب والسلم هو مسؤولية الدولة وحدها وأحد مهامها الأساس، لكن أحداً من الطامحين الجدّيين إلى بناء الدولة والدارسين لشؤون بنائها، لم تبلغ به المتاجرة بتسويق تبعيتها مبلغ التبجّح بأن احتكار السّلطة قرار السلم في “الستاتيكو الأميركي” هو سبب بناء الدولة، نقيضاً لتاريخ تحقيق سيادة الدولة في قدرتها على الحرب أساساً لبنائها، وأهليتها الحربية في احتكار قرار الحرب والسلم.
بين الدراسات القانونية وتاريخ بناء الدولة
ركائز مجمل هذه الدراسات القانونية تعود إلى تأويل قوانين “معاهدة وستفاليا” في أوروبا عام 1648، إثر الحروب الدينية الكاثوليكية- البروتستانتية التي عصفت 30 عاماً بالإمبراطورية الرومانية المقدّسة، و80 عاماً بين أجنحة “آل هابسبورغ” في الإمبراطورية الإسبانية والمقاطعات المنخفضة (هولندا).
مآسي حروب الغابة في أوروبا تحت سيطرة الإمبراطورية الرومانية المقدّسة آلت إلى انفصال الإقطاعيات المتناحرة وكنائسها المتحاربة، وإلى صعود ممالك فرنسا وإسبانيا والسويد وهولندا والإمارات الأخرى في مواجهة سلطات آل هابسبورغ وكنيستها الرومانية، فدعَت الممالك والإمارات الصاعدة إلى احتكار كلٍّ منها “قرار الحرب والسلم” بانتزاعه إلى ملكها وكنيستها من الكنيسة الرومانية وإمبراطورية آل هابسبورغ، سبيلاً لخوض حروبها القومية في ما بينها على طريق بناء الدولة – الأمة.
بناء الدولة – الأمة الإقطاعية في أوروبا هو وليد مسار تاريخي جيوسياسي أساسه الحرب بين الممالك السابقة وكنائسها القومية، من أجل توسّع نفوذ ومصالح كلٍّ منها على حساب الأخرى.
وقد عزّزه التهديد الدولي من الشرق إثر توسّع الإمبراطورية العثمانية في أوروبا الشرقية والوسطى نحو بلغاريا والمجر وتهديد شارلكان في ألمانيا، وصولاً إلى معركة فيينا الفاصلة مع الإمبراطورية الرومانية المقدّسة عام 1638 (سنوات معدودة قبل وستفاليا).
استمرار الحروب بين الممالك الأوروبية لبناء دولها القومية أدّى بها مع بداية الثورة الصناعية إلى حروب غزو العالم من أجل السيطرة ونهب الثروات والمواد الأولية وفتح الأسواق والممرات التجارية. ولا يقتصر الأمر على غزو بريطانيا للهند ولشرق آسيا وغزو نابوليون لمصر وموسكو… إنما غزت كلّ الدول الأوروبية عالم الجنوب لبناء دولها في حروب العبودية وإبادة السكان الأصليين (أميركا، كندا، أستراليا، نيوزيلاندا…).
مسار إستراتيجية الحرب وتوسّع المصالح القومية في أوروبا والعالم هو الذي وفّر شروط بناء الدولة الملكيّة والإمبراطوريات البريطانية والفرنسية والإسبانية والبرتغالية… ثم الانتقال من الملَكيّة إلى الجمهورية، ومن نظام الإقطاع والكنيسة إلى نظام الرأسمالية المدني بوجهيه المتلازمين معاً: الديمقراطي في المراكز وحروب الاستعمار في الأطراف.
جلّ ما صاحب مسار الحرب من أجل بناء الدولة القومية في أوروبا هو تسليحها بقوانين “قرار الحرب والسلم” في معاهدات واتفاقيات إقليمية، بدءاً “بمعاهدة وستفاليا” التي تلتها اتفاقيات متلاحقة مستمرّة إلى اليوم وفق موازين القوى، لتنظيم قوانين الحرب وقواعدها في مؤتمر فيينا عام 1814، ومؤتمر لاهاي الأول عام 1899، والثاني عام 1907…
ولم تحدّ كل هذه الاتفاقيات القانونية من مجازر الحروب الأكثر همجية في تاريخ البشرية (الحربان العالميتان) في أوروبا وخارجها، لكن الدول القائمة على الحرب في عصبة الأمم، ثم في الأمم المتحدة، نصّبتها كلها “معاهدات دولية للسلم” ضد حركات التحرّر الساعية للاستقلال والسيادة، ولا تعدو كونها سلاح حرب قانونية وسياسية بيد الدول الاستعمارية القديمة في أوروبا، والجديدة في أميركا، ونفخاً إضافياً في بوق المركزية الغربية المتمحورَة حول ذاتها.
السيادة انتزاع بالقوّة من “المجتمع الدولي”
البحث في سيادة الدولة هو فلسفة تناولها معظم كبار الفلسفة في إشكالية بناء الدولة، مثل هيغل وهوبس وماركس… وقد عبّر عنها إيمانويل كانط في كتابه “مشروع للسلام الدائم” بأن احتكار الدولة قرار الحرب والسلم هو نتيجة قدرتها على فرض توازن الرعب والقوّة، وليس انعدام القوّة (اعتماداً على قوانين “المجتمع الدولي”). وبناء عليه، يمكننا القول: إذا أرادت الدولة التنعّم بالسلم، فعليها امتلاك القدرة على الحرب.
انتزاع السيادة بالقوّة من دول “المنظومة الدولية” المتصارعة من أجل توسّع مصالحها ونفوذها في العالم يعود مرجعه النظري والقانوني إلى جان بودان في “الكتب الستة للجمهورية” عام 1576، وفيه إرساء بعض القواعد الحاكمة لحرب الدول وسلمها بين الإرهاصات التي أدّت إلى “معاهدة وستفاليا” وكل الاتفاقيات اللاحقة، ومن ضمنها معاهدات عصبة الأمم والأمم المتحدة ومواثيقهما.
قدرة الدولة على انتزاع السيادة بالقوّة هي القاعدة الحاكمة لاستقلالها، “وخصوصاً عن القوى الدولية”، كما يقول ريمون كارّيه دو مالبرغ عام 1920 في كتابه المرجع “مساهمة في النظرية العامة للدولة”، إذ يشترط “عدم خضوعها لأي سلطة دولية أعلى منها”.
إن بناء أهلية الدولة بالقدرة على الحرب من أجل تعزيز مصالحها الوطنية وردع الدول الساعية للتوسّع على حسابها هو إجماع لا جدال فيه على مرّ تاريخ ركائز بناء الدولة بين رجال الدولة والمختصّين بالمسؤولية العامة (راجع على سبيل المثال “أصول وركائز السيادة” بإشراف توماس باكون، ورشات عمل جامعة غرونوبل، عام 2000).
لكن الهيمنة الأميركية بالحرب نتيجة الحرب العالمية الثانية قلبت ثقافة السيادة والثقافة السياسية عموماً إلى ثقافة “سلام” طوباوية تخدم تعزيز مصالحها في “قيادة العالم”، وتخدم سيطرتها على “المجتمع الدولي” بصفتها هيمنة شرعية فوق مصالح الدول وسيادتها في تمثيل “الخير العام” للجميع.
في سبيل تأبيد التوحّش الحربي الأميركي، تحارب أميركا ومؤسسات “مجتمعها الدولي” مناهضي العبودية الجديدة وحركات التحرّر بالدعوة إلى وقف المقاومة والعنف واللجوء إلى قوانين “الشرعية الدولية” التي كلّفتها أميركا ودول الحرب بالسهر على حماية السلام العالمي. ولا ضير إذا ضربت أميركا بعرض الحائط كل شرائعها وقوانينها الدولية، وغزت الكون، وقتلت ودمّرت، “فالإمبراطورية الأميركية المقدّسة” واجبها الديني فرض الولاء والطاعة.
المقاومة عماد بناء الدولة وسيادتها
ثقافة الخضوع للعبودية الأميركية و”مجتمعها الدولي” تدغدغ أحلام براءة الأطفال التي تتوهّم تحقيق سيادة الدولة من دون تحمّل مسؤولية أعباء الحروب، فينزع مخيالها إلى الظنّ بأن “الشرعية الدولية” الأميركية حيادية عادلة في قوانينها وأدائها السياسي، تحقّ الحقوق السيادية المشروعة بتطبيق القوانين الدولية.
المؤرخ المرموق عصام خليفة مثلاً الذي يعترض على ترسيم الحدود البحرية لا ينظر في موازين القوى التي يساهم في اختلالها لمصلحة “إسرائيل” خضوع اللبنانيين ودولتهم لثقافة رفض الحرب من أجل السيادة، واعتناق ثقافة السلام الأميركي لتحقيق السيادة والأمن والاستقرار.
ولا يرى أن تهديد المقاومة بالحرب أحدث الخرق، وأن التهديد الحربي وحده يمنع “إسرائيل” وأميركا من ابتلاع الترسيم وتسويفه اليوم وغداً، بل يتوهّم استعادة السيادة التامة بالقانون الدولي سلماً، الموكلَة به محكمة العدل الدولية التي تقاطعها “إسرائيل”، والتي لم تتجرّأ يوماً على مخالفة التعليمات الأميركية وقت الجدّ.
لا تدغدغ ثقافة الخضوع للعبودية الأميركية – الدولية براءة السذاجة السياسية فحسب، بل تشبك في المقام الأول مكاسب ارتزاق دكاكين السمسرة السياسية، لقاء خدمة توسّع مصالح دول “المجتمع الدولي” واستراتيجية الحرب الأميركية للهيمنة على العالم.
هذه المصالح واستراتيجية الحرب توفّران سوقاً رائجة في منطقتنا، تتجنّد لها السعودية ومحميات خليجية بعرض بضاعتها، وتجنّد معها صغار تجارة “الكشّة” السياسية على أعتابها ضد إيران، ثمرة عنقود حركات التحرّر في دول الجنوب، من أجل الاستقلال السياسي وندّية المصالح المتكافئة في المنظومة الدولية، وضد كل ما يعوق “الباكسا أميركانا” (السلام الأميركي) في المنطقة والعالم.
الأكثر تشبّعاً بثقافة صغار الكسبَة في تجارة الدكاكين السياسية هم “سياديّون” في لبنان يجمحون إلى نزع سلاح حزب الله الذي حررّ الأراضي اللبنانية من الاحتلال، والذي يتمسّك بإستراتيجية السلاح، أحد أركان بناء سيادة الدولة، في مواجهة قاعدة الحرب العسكرية الأميركية – الدولية في فلسطين المحتلة.
وإذا كان بناء الدولة يقوم على قدرتها على الحرب بهدف توسّع المصالح الوطنية في “المجتمع الدولي”، فلا بأس بأن تتوسّع مصالح دكاكين السمسرة السياسية، فهي “مصالح وطنية” يمكنها أن تتوسّع في “سوبر ماركت” كبير، وربما “مول” – دولة “لكل لبنان وطوائفه”، فهدف توسّع المصالح هو نفسه، والشطارة اللبنانية عريقة بانتزاع اللقمة من فم أسد “المساعدات الدولية” ومآدب إخواننا العرب.
ثم إننا “نحن الدولة”. ألم يقلها لويس الرابع عشر العظيم؟ والدولة ذات السيادة تقرّر بإرادتها “الحرّة”، على هوى طبقتها السياسية، السلم للمحافظة على ديمومة المزرعة الخربَة أو الحرب في صفّ أميركا و”مجتمعها الدولي”، وفي صفّ “إسرائيل” وإخواننا العرب، لنزع سلاح حزب الله وتحرير الدولة “من الاحتلال الإيراني”، وتحرّرها من سيطرة المقاومة على الدولة في قرار الحرب والسلم.
مهضومة تجارة الدكاكين السياسية في لبنان في تسويق “خُردَة الأزقّة” بماركة عالية الجودة “شغل بلاد برّا”، مدموغة في أميركا على أعلى مستويات “ثقافات ما بعد الحداثة” وفنعات الهبَل في “السيادة وقرار الحرب والسلم” وفي إعادة “بناء الدولة – المزرعة” على الأسس نفسها التي تكسّبت فيها دكاكين السمسرة السياسية بنهبها، والارتزاق من تبديد “براغي” سيادتها الخارجية والداخلية.
اللهم لا حسد وصيبة عين لرواج التكسّب والارتزاق، لكنه وصل إلى تجارة الموت في السمسرة مع أميركا وشركائها على الحرب بدعوى “نشر السلام”، كتسلميها الاتحاد السوفياتي لقمة سائغة أملاً بالتعايش السلمي، فأعطاها دفعاً لمواصلة الحرب على أبواب موسكو والتهديد بزوال الكرة الأرضية.
“سلام” “أوسلو” و”كامب ديفيد” و”أبراهام” أعطى “إسرائيل” دفعاً مماثلاً لاستكمال حروب 48 و67 و73 و82 … واللائحة تطول في لبنان وفلسطين المحتلة، ولم يلجمها ويردعها سوى سلاح المقاومة الذي توظّف أميركا و”إسرائيل” والسعودية “مواهب” أتباعها في التحريض لنزعه. ولا ريب في أن الذي يئد نار لعبة الموت يخاطر بإحراق أصابعه وأكثر.


