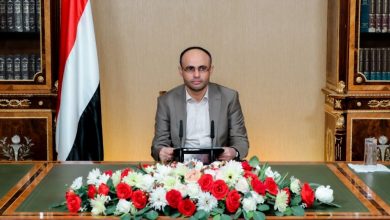تقديم الإسلام من خلال الرسول الرحمة
تُعْتَبَرُ حركةُ الرسول صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وسلم التغييريةُ نموذجاً يُحْتَذى به في حركتنا التغييرية التي نعايشُها اليوم، فهناك ما هو أمرٌ ثابتٌ وقطعيٌّ، ويجب التأسي به فيه؛ باعتبَارِ تحَرّكاته وأقواله هي القدوة والأسوة، وهناك من الأمور النسبية التي تختَلِف باختلاف الأحوال والظروف، مثل اللين في أموره الشخصية الخَاصَّة، والالتزام الجاد في أمور المسلمين العامة، فهذا أَيْـضاً له مدخلٌ كبير في باب التأسي والاقتداء.
اختصَّ نبينا محمد صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وسلم بتوثيق أحداث حركته على خلاف الأنبياء والرسل السابقين، الذين ليس هناك في أيدينا اليوم ما نثق بصحة الأحداث المنسوبة إليهم، والتحَرّكات المرصودة عنهم، إلا ما حكاه القرآن الكريم، أما سيرة رسول الله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وسلم التي هي سنته وطريقته ومنهجيته، التي هي أقوالُه وأفعالُه وتقريراتُه فقد دوِّنت تدوينًا دقيقًا بشكل يتميّز عن الأمم الأُخرى، ورغم دخولِ كثيرٍ من الأشياء المكذوبة عليه صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وسلم بفعل أسبابٍ وعواملَ سياسية وحضارية وثقافية ومذهبية، إلا أنه يبقى الحظُّ الكبيرُ منها سليما صحيحا، وبوجود القرآن الكريم مهيمنا على كُـلّ شيء، فإن الباحث الحصيف يستطيع اكتشاف الصحيح منها والباطل، بشرط أن يخضع لمنهج النقد والفحص والتمحيص.
لقد نجح رسول الله نجاحاً باهراً في تقديم الإسلام، وفي غضون سنوات قليلة غير العالم، وأنتج رقيا وسموا للإنسان، بينما هناك حركات تدعي الإسلام، لم تغير الواقع إلى الأسوأ، فكيف قدم الرسول الإسلام؟ وكيف قدمته هذه الحركات؟
هذا المُشكِل هو ما تحاول هذه المقالة الإجابة عنه..
الحركة التغييرية النموذج
قدّم رسولُ الله تجرِبةً بشرية مِعطاءة في الحكم والقيادة والدعوة والإرشاد، وبلّغ عن الله بلاغا مبينا، حمد اللهُ فيه سعيَه، وهي تجربةٌ عملية واقعية، ارتقت الأُمَّــة من خلالها رُقيًّا كبيراً، وزكى عالَم ذلك الزمان زكاءً بالغا، وما أحرانا اليوم وقد عادت بنا حليمةُ الجاهليات إلى عاداتها القديمات، إلى أن نتوجّـهَ صوبَ هذه الحركة النبوية في هذه المناسبة الشريفة لكي نستفيدَ منها ما يساعدُنا على اجتياز هذه التحديات التي تواجهنا اليوم.
حركةُ رسول الله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وسلم الراقية بالإنسان وبقلبه وعقله إلى العلياء هي حركة نموذجية، وقد ندبنا الله -عَــزَّ وَجَـلَّ- إلى الاقتداء بها، والحذوِ على مثالها، إذَا شئنا أن يرتقي واقعنا، وأن نتصل بالله ونرتبط به كمال الارتباط، كما تُعتَبَرُ نموذجا يقاس عليه التجارب الأُخرى سلبا أَو إيجابا، بحيث تُشكِّل هذه التجربة مقياسا ونموذجا مُلْهِمًا لكلِّ مَنْ يريدُ التأسيَ والاقتداء، ولمن يريد القياس والتقييم.
وأيضا فقد مرَّ رسولُ الله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وسلم بظروفٍ مشابهةٍ إلى حدٍّ كبير لهذه الظروف التي نمرُّ بها اليوم، أما كيف اجتازها وكيف تعامل معها فهذا هو ما يهمُّنا اليوم أن نعرفه تصوراً وعقيدة ومبدأً وسلوكاً، حتى يأخذ بأيدينا نحو الطريق المحمدي والنتائج الإيجابية التي ستنتج عنه.
تقديمٌ عقليٌّ عاطفي سلوكي مُتكامِل
لقد قدَّم رسول الله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وسلم الإسلام تصورا نظريا يلبي حاجة العقل، وينسجم مع قضاياه ومنطقه، كما قدَّمه في ذات الوقت مبادئَ وقيما عادلة يلتزم بها، ولا يتجاوزها، ولبّى حاجة القلب بأن قدَّمه أَيْـضاً في جوٍّ محفوفٍ بالعاطفة الجيّاشة المُنضبِطة لحكم العقل وسلطان البرهان، فكانت القلوب أسرعَ إلى الاعتراف به والتفاعل معه، وفي ذات الوقت أَيْـضاً قدّمه سلوكا وتطبيقا بالفعل والقول ملتزِما به في مختلف الحالات، مُتمسِّكا به في جميع المقتضيات.
حين قدّمه تصوراً ونظرية لم يكن مجنِّح الخيال بعيداً عن واقعه؛ لأَنَّه مبلغٌ عن الله، والله أعلم بما يصلح عباده، وبالتالي فقد كانت جميع تصوراته النظرية تؤسِّس الإطار العام لهذه الرسالة العظيمة، هذه التصوُّراتُ النظرية لبَّت الحاجة العقلية والفلسفية للإجابة عن الأسئلة الحائرة عن هذا الكون، وعن مُنشِئِه، وخالقِه، وصفاته، وعلاقته بالكون، وعلاقة أهل الكون ببعضهم، وقدّم مفاهيمَ تصوريةً دقيقة تُهيِّئُ الإنسان في مجملها لأَن يعيشَ منسجمَ العقل والعاطفة والسلوك، كُـلّ جانبٍ منها يخدم الجانبَ الآخر، فدعا إلى التوحيد لله المُتنزِّه عن صفات النقص، والاعتقاد بعدله وحكمته، والإيْمَـان بملائكته ورسله، والإيْمَـان باليوم الآخر، إلى آخر تلك العناوين الفاعلة والمصيرية التي تنعكس وجوباً على العاطفة والسلوك.
بهذه الخطوة التي تُعتَبَر بلاغاً عقلياً أفسح الرسولُ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وسلم الطريقَ للبلاغ العاطفي والشعوري، أراد للمشاعر أن تتحَرّك باتّجاه الله تَعَالَى بشكلٍ متوازٍ مع العقل، لكي تُنتِجَ في المحصِّلة سلوكاتٍ طيبة وطرائقَ فطريةً حميدة تنتهي برضوان الله عن هذا الإنسان، وتجعله مرتبطاً به -سُبْحَانَــهُ وَتَعَالَى- منشدًّا إليه.
لقد دعا الرسلُ البشرية إلى الله تَعَالَى، وتلوا عليهم آياتِ الله لكي ينشّدوا إليه، لكي يرتبطوا به، لكي يعيشوا حالة اليقين والشعور بالله في كُـلّ لحظاتهم، وفي كُـلّ أوقاتهم، لكي يكتسبوا أخلاقَ الرحمة التي هي من صفات الله، ولكي يكونوا أقوياء بالله، فيُحِقُّوا الحق، ويُزهقوا الباطل، ولكي يعيشوا حالة الارتباط بالله، فيسعوا في مرضاته، ويتحَرّكوا في سبيله، في محياهم ومماتهم، في رضائهم وحزنهم، في سعادتهم وشقائهم، في سرائهم وضرائهم، في حربهم وسلمهم، لكي يكونوا مرتبطين بالله تَعَالَى دائماً وأبداً.
ولا شك أن هذه الحالة العظيمة هي من تُعطي الزخم الكبير، والقوة الجبارة لهذا الإنسان الضعيف، هي من تُكْسِبُه قوة هائلة، وقدرات عظيمة، ولهذا يجب أن لا نذهب بعيداً في تفسير حالة الصمود لدى إخواننا المرابطين في الجبهات وهم يؤدون ملاحمَ أسطورية في الثبات والرقي والارتباط بالله تَعَالَى، ذلك أنهم تلبّسوا بهذه الحالة، ووصلوا إلى هذه الدرجة من التعلُّقِ بالله، والإيْمَـان به، والانشداد إليه، والشوق إلى لقائه.
البلاغُ المبين
الرسولُ العادي هو ذلك الذي يُبلِّغ رسالة المرسِل بلاغاً حسيًّا ينتهي عند وصول الرسالة، ولا يهمُّه كيفما كانت النتائج، أما الفيلسوف فهو الذي يهمُّه البلاغُ العقلي، إذ يحزم حقائب أدلته، ويجمع مقدماتها، لكي يصل إلى عقل المُرسَل، ثم إذَا وصل إلى عقله لا يهمه ما يكون بعد ذلك، وماذا سيكون عملُه وسعيُه، وأيَ سلوك سلك، وأي طريق مضى.
بيد أن بلاغَ الرسل هو البلاغ المبين الذي حكاه القرآن الكريم عنهم سلام الله عليهم.
الرسول هو ذلك الذي يبلّغ عن الله تَعَالَى، فيملأ فراغَ العقول بسلطان الحجج والبراهين الهادفة والتي تُشكِّل جزءا واحدا فقط من منظومة الإسلام التي تتجه بأهلها إلى الله، وتريدُ أن تحُطَّ برحالهم على عتبة رضوانه تَعَالَى، ثم يستجيش المشاعرَ والعواطفَ نحو هذه المعرفة العقلية لكي يكون سلطانُ العقل محشودًا بسلطان الضمير، مؤيَّدا بقوة وسلطة المشاعر، ثم يتحَرّك في موقع المسؤولية والقدوة إلى ترجمة تلك المعارف وتلك العواطف إلى واقع عملي ملموس، وإجراءات سلوكية هادفة، ويكون الرسول هو أول من يطبقها، ويعمل على أَسَاسها.
وظائفُ الرسول من واقع صفاته القرآنية
لا يكتفي الرسول بذلك بل يكون الرسولُ قبل البلاغ وخلاله وبعده شاهداً على هؤلاءِ القوم أيُّهم يسارع إلى العمل، وأيهم يُبطِئ، إنه الشاهد المُطّلع على الأعمال، ويكون في ذات الوقت مبشِّرا قائدا لمن يعمل بمقتضى الحق والفضيلة والخير إلى رضوان الله، وفي ذات الوقت أَيْـضاً يكون نذيرا يسوق المتأخِّرين والناكصين والمتساقطين على قارعة طريق التكاليف، يُنذِرهم سوءَ اختيارهم، وعاقبةَ نكوصهم، ولا يفتأ يذكر ويدعو بين الفينة والأُخرى إلى الله، يُحاول ربطَهم بالغاية العظيمة وهي الارتباط بالله تَعَالَى، وتوجّـه القلوب إليه، والرتوع في مرضاته، ولا يتركُهم بعد ذلك أَيْـضاً بل يشكِّل بتعاليمه وتحَرّكاته وموقعه ورسالته وأهدافه نورا مبينا، وسراجا منيرا، لهؤلاءِ الذين قد تُعشِيهم الظلمات، وقد تَخبِطهم المصيبات، في لحظة من لحظات الضعف، أَو حالة من حالات الاختبار والبلوى.
ألم يقل الله تَعَالَى لنبيه الكريم في سورة الأحزاب: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً{45} وَدَاعِياً إلى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجاً مُّنِيراً {46} وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلاً كَبِيراً{47} وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً{48}}الأحزاب
الآية تبيِّن عَدَداً من الوظائف الرئيسة التي قلّد الله نبيَّه بها، فهو مرسَل، وشاهد، ومبشر، ونذير، وداعٍ إلى الله، وسراجٌ منير، ثم يأمره تَعَالَى في لفتِ خطابٍ قويٍّ ومُلفِت، بانتقاله من سياق الإخبار بوظائف هذا النبي، إلى سياق الأمر له بالتبشير للمؤمنين بالفضل الكبير، وبعدم إطاعة الكافرين والمنافقين، والتوكل عليه، والركون إليه. فكأن الرسول قد دعا المدعوِّين إلى الله، وكأنهم قد نَذِروا، واستبشروا، وتحَرّكوا باتّجاه مرضاة الله، واستفادوا من النور الذي يسَّره لهم؛ ولأنهم كذلك فإن الله يأمر رسوله أن يُبَشِّرَهم بفضلٍ كبير، والفضلُ هو الزيادة في الجزاء، والإنعام، والوصف بالكبير، يعني الفائق في جنسه، أي أن هذا الفضل هو شيءٌ فائق على جنسه، عَدَداً، ونوعاً، وهيئة، ووصفاً.
البشارة أولاً
كثيرة هي آياتُ القرآن التي تصفُ الرسول بأنه البشيرُ النذير، لكنها جميعاً قدمت وصفه بالبشارة على وصفه بالنذارة، ففي سورة البقرة: (إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً)، وفي سورة الإسراء: (وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ مُبَشِّراً وَنَذِيراً (105) وَقُرْآناً فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلاً (106))، وفي سورة الفرقان: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّراً وَنَذِيراً)، وفي سورة سبأ: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً)، وفي سورة فاطر: (إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً)، وفي سورة الفتح: (إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً).
اللهُ قدّم رسولَه على هذا النحو، بشيرًا ونذيراً، لكنَّ دينَ الرحمة والفطرة والإنسانية الذي هو الإسلام تأتي البشارة فيه دائماً قبل النذارة، يأتي كونُ الرسول الرحمة مبشِّرا أَو بشيرا بالجنة وبرضوان الله قبل كونه نذيرا ومنذرا بعذاب الله، وهو أي التبشير برحمة الله، والتأكيدُ على مجازاة الله لعباده بالرضا والرضوان والفضل والإنعام أمرٌ شائعٌ وكثيرٌ في القرآن الكريم، وهو يُشير إلى طبيعة وغاية حركة الرسول صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وسلم، في أنها لم تكن إلا رحمة عامة لجميع العالمين، كما تؤكّـدها آية (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين).
دعوة إبراهيم عن الرسول والأُمَّــة
أهمَّ سيدَنا إبراهيم عليه وآله السلام أمرُ البشرية وراءه حين يحتويهم الضلال المبين، فخرج يدعو الله -عَــزَّ وَجَـلَّ- بأن يُرسِل إلى ذريته رسولا منهم، قال عز من قائل في سورة البقرة حاكيا دعاءه الكريم: (رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ العَزِيزُ الحَكِيمُ).
لقد حدّد أبو البشرية الثاني، أبونا إبراهيم مواصفاتِ ووظائفَ النبي الكريم، بأن يكون منهم؛ لأَنَّه سيكون أدعى للقبول به، وفيه شرُفهم وعزتهم ومجدهم، لو حكّموا سلطان العقل، وأنه (يتلو عليهم آيات الله)، وهو البلاغ المبين الذي تحدثنا عنه سابقاً، وأنه يُعلِّمُهم الكتابَ، فيبنون عليه تصوراتهم الصحيحة، حتى لا تصيبَهم طامَّةُ الجهلِ، وآفاتِ التصوُّرات الفاسدة، وأن يُعَلِّمهم الحكمة، فتكون لديهم حكمة في الرؤية، وحكمة في الطريقة، وحكمة في السلوك، ويحصلون على فضيلة الزكاء التي تُطهر صاحبَها وتُحلِّقُ به في سماء الربانيين، ليكون الإنسان الكامل، والأُمَّــة الكاملة والراقية والسامية.
استجاب الله سُبْحَانَــهُ لهذه الدعوة الإبراهيمية، فقال في سورة البقرة آية 151: (كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ)، وأكّـد ذلك في آل عمران آية 164حين قال: (لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ)، وفي سورة الجمعة، آية2 لما قال: (هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ).
منظومة تفاعلية واحدة
إذن من خلال هذه الآيات يتَّضِحُ أن الرسولَ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وسلم قدّم الإسلام في حركة تفاعلية رائدة، تخاطب العقل، والشعور، والسلوك في آن واحد، ومن خلال منظومة واحدة، فهو يتلو عليهم الآيات البينات، التي تُذعِنُ لها العقول فتصدِّقها، وعندئذ تتزكّى نفوسهم، وتطْهُرُ قلوبُهم، وهذا تفاعل وجداني ضروري ينتقل بالحالة المعرفية الجافّة إلى حالةٍ وجدانية تفاعلية، وبتهيؤ نفوسهم واستعدادها لتقبل التعاليم التفصيلية والمنظِّمة للعلاقة بينهم وبين جميع الموجودات من حولهم، فهو يعلِّمُهم الكتابَ؛ لأَنَّه مستودَع دستورِ الله الذي ينظم العلاقة بين الله وخلقه، وبين أنواع الخلق أَيْـضاً، ولا يكفي أن يسود التنظيم للعلاقة وللسلوك بل لا بد من سيادة القراراتِ الصائبة والحكيمة، فيعلِّمُهم الله الحكمة، التي هي القرار المناسب، وإيقاع سير الحياة على النحو الحكيم الذي يعني -؛ باعتبَارِه مؤشرا – الرقي والسمو للأُمَّــة.
ولما امتن الله عليهم، وأراد تذكيرهم بنعمه التي أسداها إليهم، تحَرّكت آية القرآن بشكل ملفت وسريع لتعقد مقارنة حكيمة بين وصول هؤلاءِ المبلِّغين والأقوام بفعل تحَرّك الرسول صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وسلم بهم إلى حالة الحكمة، وهي حالة الرقي والسمو وحالة الضلال المبين التي هي حالة الجاهلية، وما بينهما من فرق يوضِّح عظيمَ نعمةِ الله على بني الإنسان بإرساله هذا الرسول إليهم، فيا له من فرْقٍ عظيمٍ وشاسع، ويا لها من نعمة كبيرة وعظيمة.
معرفة موجَّهة، وشعورٌ فياض، وسلوك معبر، وشمولية متنوعة
قدّم الرسول الإسلام بصورة عظيمة ومحبة، فأنبت في العقول معرفة الله، وبنى فيها التصور الإسلامي الراقي عن الله والكون وما فيه، وأن الله هو الرحمن الرحيم، القادر على كُـلّ شيء، والعالم بكل شيء، والحكم العدل بين العباد، قدّمه شعورا فياضا بالرحمة، كما قدمه سلوكا نيرا ومُعَبِّرا عن تلك المعرفة وذلك الشعور بشكل طبيعي ومنسجم.
قدَّمَه بأن يكون الإنسان مرتبِطا بالله ومرضاته، يتحَرّك الفكرُ فيه مع التصور مع العاطفة مع العقل مع السلوك في آنٍ واحد، ويسمو بالإنسان فيه، ويرقى به فكرا وتصورا وشعورا وسلوكا وهدفا وغاية، قدَّمه على أنه حَلٌّ لمشكلات الإنسان، لا مُبتكِرٌ لها، وأنه يهدِف إلى تكريم الإنسان أولا، والإنعام عليه بإغداق المكارم والنعم.
قدَّمه متنوِّعا يكمِّل بعضُه بعضا، كمنظومة كاملة متكاملة لا يقوم بعضه إلا بالبعض الآخر، والجانب الواحد منه يخدم الجانب الآخر.
وبالفعل فبينما كان صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وسلم يبني التوحيد في العقول والقلوب، ويشد المسلمين إلى الثقة بالله تَعَالَى، كان يمارس بنفسه هذه الأمور عمليا، فيشهدُها صحابتُه على النحوِ الذي أخبرهم سلَفاً، ثم يتحَرّك في الميدان العسكريّ، الموازي للميدان العقلي والمعرفي، وفي ذات الوقت يبني المجتمع المسلم على أَسَاس تلك المبادئ والأخلاق التي نادى بها، وفي ذات الوقت يبني المنظومة الاقتصادية للمجتمع بالشكل الذي يخدم الجوانب الأُخرى، فيضيف إلى قوة المجتمع قوة إضافية أُخرى، وهكذا كان ينسج نهضة المجتمع جانبا بجانب، وأمرا بأمر، ومجالا بمجال، وعلى أَسَاس الهدى والنور من كتاب الله وتعاليمه، الأمر الذي أتاح نهضة سريعة وواسعة وشامِلة ومتنوِّعة، في غضون سنوات قليلة.
لقد قدّم رسول الله الإسلام على أنه قيم جادة، ومبادئ محترمة، ومنهجية رائعة وسامية، قدَّمه كمشروعٍ يتحَرّك فيه جميع الأُمَّــة لا يحتقَر فيه عمل عامل، ولا يغيَّب فيه دورُ إنسان ذكرا أَو أنثى، على أَسَاس المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والإمْكَانات، وعلى أنه دين الأمن والسلام، والقوة والنهضة، والرحمة والتكريم.
الرسولُ الرحمة
القرآنُ الكريم والسُّنة النبوية الصحيحة يشرحان شرحا واسعا تحَرّك الرسول صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وسلم، وهل هناك أجمل من قوله تَعَالَى شارحا المشقة النفسية التي واجهت الرسول صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وسلم عند كُـلّ ما كان يخشى أن يعنَت فيه المؤمنون، فقال تَعَالَى: (لقد جاءكم رسولٌ من أنفسِكم عزيزٌ عليه ما عنتم حريصٌ عليكم بالمؤمنين رؤوفٌ رحيم)؟!؟
وهل هناك تصويرٌ أروع من قوله تَعَالَى: (مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ)؟ ومن قوله تَعَالَى: (وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ)؟ ومن قوله تَعَالَى: (فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ)؟.
هل نجد إنسانا كاد يُهْلِكُ نفسَه أسىً وحسرة حين لم يؤمن بعضُ أمته، فخاف عليهم الهلاك، فقال تَعَالَى عه: (فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفاً)، (لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ)، والبخع قتل النفس. هل هناك أروع من هذا النبي صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وسلم، وأرحم، وقد كاد يُهلِك نفسَه ويقتلها أسىً على أولئك الكفار؛ لأَنَّهم لم يُسلموا، لهذا نهاه الله -عَــزَّ وَجَـلَّ- قائلاً: (فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ).
ويكفي الرسول الكريم صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وسلم أنه ما كانت رسالته إلا رحمة لكل العالمين، وخذ من هذه العبارة (رحمة للعالمين) ما شِئْتَ من رُقِيٍّ وسُمُوٍّ وإكرام وإنعام وعطف وحنان وعدل واهتمام.
إن تقديم الإسلام بهذا النحو الرائع عقليا، وإنسانيا، وعاطفيا، وسلوكيا، وواقعيا، وتكامليا، وكونه حزمة كاملة، ومهتما بالإنسان، وهادفا إلى رقيه، وسموه، والرحمة به، وتحريكه نحو الله، وباتّجاه مرضاته، كان له الأثرُ الكبيرُ في نجاحه السريع، وسرعة انتشاره، وحدوث التغيير المنشود منه، وقوة تأثيره.
إسلام المتأسلمين.. جاهلية جديدة
أما كيف قدَّمه التكفيريون وكيف قدَّمَتْه الأنظمة المُتَأسِلمة والعميلة للمستكبِرين من الأمريكان والصهاينة فهذا أمرٌ لا يحتاج كثيرا من الشرح؛ لأَنَّ مأساة الواقع الذي يعيشُه المسلمون تتلخّص في العبارة التي أطلقها السيد القائد في خطاب المولد النبوي الشريف لعام1437هـ، لما قال عن هذه الحالة السيّئة والتي أشنعُ وأفظعُ مظاهرِها العدوانُ على اليمن، لقد قال: (هذا هو إسلام السعودية، وديمقراطية أمريكا).
هذه العبارة من جوامع الكلم تُلخّص بعمقٍ حكيمٍ وكثافةٍ عجيبة الحالةَ الجاهلية التي نعايشها اليوم، والتي يُشكِّل العدوان السعودي الأمريكي على اليمن أحد مظاهرها الرهيبة، إنها الجاهلية الأُخرى، التي عناها الرسول صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وسلم بقوله: “بعثت بين جاهليتين، لأخراهما شر من أولاهما”.
وإني لأعجب من المفسرين لما مروا على قول الله تَعَالَى: (ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى) تاهوا في البحث عن الجاهلية الأُخرى، فخبط كُـلّ منهم ما سولت له نفسه، فقال بعضهم: إن الجاهلية الأولى كانت في عصر نبي الله إبراهيم، وآخر قال خلاف تلك العبارة، ذلك لأن الكثير منهم رفض النظر إلى مرويات أهل البيت عليهم السلام عن رسول الله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وسلم، ولو أنهم اطلعوا عليها لوجدوا حديثا صحيحا من صحيح مروياتهم، يتحدث عن الجاهلية الأُخرى، وهي هذه الجاهلية التي نعيشها اليوم، والتي هي شر من الأولى التي كان مبعث رسول الله قاضيا عليها، ومطيحا بها، فلم يحتاجوا إلى تلك الافتراضات البعيدة.
إن شناعة هذه الجاهلية التي نعايشها أن يأتي نظام آل سعود ومخرجاته الدينية ليدّعي التمثيل الحصري للرسول الكريم صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وسلم، وأنهم هم الوكلاء الوحيدون والأفضلون لهذا الإسلام، ولهذا الدين، ولهذا الرسول، ثم لا يدَعُون أمرا من أمور الإسلام إلا ويهدِمونه، ولا قضيةً عادلة من قضاياه الكثيرة إلا ويتحايلون عليها بشكل مفضوح وواضح، ولهذا للمرة الألف أثبت العدوان السعودي الأمريكي على اليمن أن الإسلام السعودي الأمريكي أبعد ما يكون عن الإسلام القرآني المحمدي الأصيل، ورأى العالم كله كيف سقطت المنظومة الدينية السعودية الوهّابية في هذا الاختبار، لتحتشد خلف الطغاة والعملاء في هذا العدوان، وتبرر وتسوغ الجرائم والمآسي التي يرتكبونها يوميا ضد شعبنا وأمتنا.
الإسلام الوهّابي السعودي والداعشي مشكلة تستدعي المراجعة
مشكلتهم أنهم قدموا الإسلام بشكل تجسيمي، يُجسِّم الله ويشبِّهه بخلقه، ثم قدموه في قالب عاطفي متوحش، وبلا ضمير، ولا أخلاق، ولا قيم، وبسلوكات متوحّشة ومتناقضة ومزدوجة وتناقِضُ الإسلام في كثير من جوانبه.
وإذا كانت الرحمة للعالمين هي أهم رسالة وهدف وغاية بُعِث الرسولُ من أجلها، بل كان إياها، فأين هي هذه الرحمة في هذه الحركات التكفيرية ومنتجيها، وفي هذه الأنظمة ودعاتها وهم يستهدفون يمن الإيْمَـان والحكمة على هذا النحو الذي نشاهده؟!
أليست الرحمة غائبة عنهم حتى فيما بينهم، أليسوا يتناحرون ويتحاربون وهم ينتمون لذات المدرسة، وقد تخرَّجوا جميعاً من ذات الفكر، ومع ذلك يكفر بعضهم بعضا، ويقتل بعضهم بعضا، هذا يفجر مسجد هذا، وهذا يفخخ مدرسة هذا، وهذا يقتل نساء هؤلاءِ، وهؤلاءِ يقتلون أطفال أولئك، وحتى الحيوانات حين يُحدِق الخطر بها فإنها تتوحّد وترحم نفسها، أما هؤلاءِ فهم والموت بات قاب قوسين أَو أدنى منهم في حلب بعد اشتدادِ الخناق عليهم من الجيش السوري، وكما يحصل بين الفئات الدينية المتناحرة من أولياء العدوان السعودي الأمريكي في الجنوب وعدن بالتحديد، وَإذَا بهم يستمرون في تكفير بعضِهم، وقتلِ بعضِهم بعضا، بشكل يجعلُنا من اليقين في أعلى مستواه أنه لا رحمة لديهم، وأنهم بعيدون كُـلّ البعد عن رسول الله وعن رسالة الإسلام.
إن تقديمهم للإسلام بهذه الطريقة البشعة ساهمت في حالة الارتداد عن الدين، وكُرهِ كثير من شباب المسلمين له، الأمر الذي يُصحِّحُ أنهم حصادٌ رديء احتطبه الاستكبار العالمي لغرضِ تشويه الإسلام، وزرعهم في البلدان والشعوب الإسلامية لجعلهم مقدمات وإرهاصات لوجوده.
هذه الجماعات المتأسلمة إذَا دخلت بلدا من البلدان، قال الاستكبار العالمي: وأنا أتبعكم أيها الأحباء.
لقد قدموه وهم مع أعدائه سمن وعسل، وبرد وسلام، إن لم يكونوا عملاء بشكل مباشر أَو غير مباشر، أما على المسلمين فقد قدَّموه على أنه عنف (قتل – ذبح – حرق – سحل – شدة – قساوة – تزمت وغلو – تناقض وازدواجية)، قدموه على أنهم رحماء على الكفار، أشداء على المسلمين أَو حتى على بعضهم، قدّموه على أنه موالاة اليهود والنصارى المستكبرين، والمسارعة في حبهم، ومصالحهم، والتنفيذ لخططهم، قدموه على أنه الشدة على الشعوب، وانعدامُ الرّحمة بهم، وعلى أنه السعيُ الحثيث في طمس معالم الدين الحنيفي السَّمْح، على أنه دينُ القتل، والسوداوية، والعنف، والغِلظة، والفظاظة، والشدة، والكراهية، والوقوف إلى صف المستكبرين والظالمين، والدعاء لهم، والمسارعة فيهم، وجلد المستضعفين، والتحريض عليهم، والتنكيل بهم، وإصدار الفتاوى الكاذبة المُبيحة لدمائهم.
وآخر فظاعات دينهم هذا البعيد عن الإسلام، والتي يجب أن لا ينساها أي يمني هو هذه الفتاوى التي أطلقها ويطلقها كبار علماء بلاطهم، ووعاظ سلاطينهم، ضد اليمنيين، بإباحتهم لدمائهم، وأموالهم، وأعراضهم، وديارهم، بشكل لم يعرف له التاريخ مثلا، وهذا ما يستدعي أولئك المتدينين اليمنيين المغرّر بهم ممن تعلم في مدارس وجامعات الوهّابية السعودية أن يراجعوا دينهم، ووضعيتهم، فقد تبين الصبح لذي عينين، وتميز الخيط الأبيض من الخيط الأسود من هذه الحركات، وحريٌّ بالجميع العودة إلى مدرسة الحبيب محمد صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وسلم، ومولدُه الشريف مناسَبة عظيمة لذلك.